في الوقت الذي كانت فيه القوات الأمريكية تنسحب من العراق عام 2010، كانت جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في تلك البلاد تشبه رجل منهك كان يدفع صخرة ضخمة على تل منحدر. وكانت قوة الدفع هذه قد بنيت بشق الأنفس حتى مع اقترابها من القمة. فهل كان من الآمن أن يتوقف الدفع دون عمل شئ سوى التمني بأن يؤدي الزخم إلى إيصال هذه الصخرة إلى القمة؟ أم هل ستتوقف هذه الصخرة ثم بعد ذلك تستدير ببطء على نحو مخيف نحونا؟
الآن نحن نعلم — ولكي نكون صادقين — أن الإجابة لا تكاد تكون مفاجأة. فالعراق هذه الأيام تعتبر دولة منهكة جداً، ولم تأتي أي من مشاكلها من فراغ. ففي الموجة الأخيرة من المواجهات الطائفية والعرقية الدامية، ضربت تفجيرات منسقة المناطق الشيعية المجاورة في بغداد وشمال العراق أيضاً، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 30 شخص. وقد تلت موجة العنف هذه، الاشتباكات التي وقعت بين الجيش العراقي والمحتجين والمتمردين السنة في الشهر الماضي حيث فقدت الحكومة الفيدرالية السيطرة بصورة مؤقتة على بعض مراكز المدن والأحياء الحضرية المجاورة في كركوك ونينوى وديالى.
وقد اجتمعت العديد من المؤشرات السلبية: فالمليشيات المدنية المسلحة تعيد نشاطها، والتفجيرات الانتقامية تستهدف المساجد السنية والشيعية، وبعض القوات العسكرية العراقية بدأت تنهار وتنقسم إلى عناصر عرقية وطائفية أو تعاني من التغيب المزمن. كما بدأت قطاعات عديدة من الطيف السياسي العراقي — الأكراد والعرب السنة والشيعة — تتذمر بشأن عدم قدرة الحكومة على التعامل مع الظلم السياسي أو الاقتصادي وبدأت تتحدث بجدية عن التقسيم.
في الثالث والعشرين من نيسان/أبريل، أخطأ الجيش الفيدرالي في حساباته عندما تحولت غارته التي شنها على موقع للمحتجين في مدينة الحويجة شمال العراق إلى اشتباكات دموية وتبادل لإطلاق النار مما أدى إلى مقتل العشرات. وهذا الحادث يحمل في طياته القدرة للتطور إلى فرصة للمجموعات المتمردة — مثل تنظيم «القاعدة في العراق» والحركة النقشبندية البعثية الجديدة — للدعوة إلى التظاهر، ويمكن لهذا التصرف أن يتناسب مع دعوات هذه التنظيمات للمقاومة المستمرة ضد "الاحتلال الصفوي" للعراق — في إشارة إلى السلالة الفارسية التي تثير مخاوف العرب السنة من الحكومة التي يرأسها الشيعة في بغداد.
ويظهر تجدد أعمال العنف في العراق منذ عام 2010 بشكل واضح جداً في المقاييس المستخدمة لقياس قوة التمرد. وقد قام معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بتتبع أعمال العنف في تلك البلاد منذ عام 2004 من خلال "قاعدة بيانات العنف في العراق" التي يحتفظ بها المعهد، عن طريق الاعتماد على معلومات من مصادر مفتوحة أو خاصة مقدمة من قوات الأمن في العراق. ففي الربع الأول من عام 2011، انخفضت الهجمات الشهرية إلى أدنى مستويات لها حيث وصلت إلى معدل 358 حادث — وهو أقل معدل ربع سنوي منذ عام 2004. وبحلول الربع الأول من عام 2012، كان متوسط عدد الهجمات الشهري قد ارتفع إلى 539. وبحلول الربع الأول من عام 2013، ارتفع معدل الهجمات الشهري إلى نحو 804. وهذه الإحصائيات لا تقدم أدلة على تزايد نشاط المتمردين فحسب بل توفر إثباتات على أنها انتقلت من استهداف الأمريكيين إلى قيام عراقيين باستهداف عراقيين [على أساس طائفي].
لذا فما الذي سيحدث بعد ذلك؟ يرى بعض المراقبين المحنكين، مثل السفير الأمريكي السابق لدى العراق رايان كروكر، أن الفترة الحالية تعتبر بمثابة عودة إلى ظروف عامي 2006 و 2007، عندما انغمست العراق في أعمال عنف مشابهة لحرب أهلية. لكن هناك مقارنة بديلة يمكن أن توازي على الأقل الاهتمام الخاص بنظيرتها — وبالتحديد الفترة المبتدئة في 2003، عندما تسببت أخطاء الائتلاف الدولي في فتح الباب أمام الجماعات العراقية المتمردة لتنمو في المقام الأول. والآن تقع الحكومة العراقية في العديد من نفس الأخطاء التي وقعت فيها الولايات المتحدة في تلك الأثناء: فهي تقوم بعزل السنة واحتلال مجتمعاتهم مع تبني نهج عسكري قاسي لا يميز بين المحاربين المتطرفين وجمهور المدنيين المسالمين.
وقد حاولت الحكومة العراقية إلقاء اللوم في فشلها على الثورة السورية، بحجة أنها تعاني من امتداد العنف من جارتها. بيد أن هذا العذر لا أساس له — حيث توقفت التحسينات الأمنية قبل بدء الأزمة السورية في ربيع عام 2011. ولا يمكن أن يُعزى تزايد أعمال العنف فقط إلى الأحقاد القديمة بين السنة والشيعة: فما أذكى نار الطائفية من جديد هو عدم رغبة حكومة بغداد في تلبية المطالب الخاصة بإنهاء العقاب الجماعي للسنة عن الجرائم التي ارتكبها نظام البعث.
ويمكن القول أن المحرك الرئيسي للعنف في العراق هو الإفراط في مركزية سلطة بغداد، الذي جاء في وقت مبكر جداً وكان مشمولاً بالذعر الطائفي. وكانت الولايات المتحدة تتحسب لهذا الخطر منذ البداية: فصيغة "المحاصصة" كانت حجر الزاوية للسياسة الأمريكية في العراق حتى عام 2008، كما أن الولايات المتحدة تأكدت أيضاً أن مبدأ اللامركزية الإدارية جرى طبخه في الدستور العراقي. وقد عكست هذه السياسة حقيقة قوية — أن العراق في مرحلة ما بعد صدام لم يكن جاهزاً لنظام سياسي يقوم على أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يفقد كل شيء.
ولكن في بداية عام 2008، أعاد المالكي مركزية الحكم معولاً في ذلك على دائرة ضيقة بشكل متزايد من المعارضين الشيعة للنظام الدكتاتوري السابق. ومثلها مثل جميع الثورات الناجحة، أصاب هذه المجموعة الريبة والشك من الثورة المضادة وبدأت في إعادة بناء نسخة من النظام السلطوي التي سعت لإسقاطه على مدار عقود. وتهيمن الدائرة المقربة من المالكي على اختيار القادة العسكريين وصولاً إلى مستوى الألوية وتسيطر على المحكمة الفيدرالية كما سيطرت على البنك المركزي. كما طمست السلطة التنفيذية بشكل سريع جميع الضوابط والموازين التي وضعت قيد التنفيذ لضمان عدم ظهور أي حكم استبدادي جديد.
وبالتالي، فإن جذور العنف العراقي لا ترجع إلى الأحقاد القديمة بين السنة والشيعة أو الأكراد والعرب ولكن بين دعاة المركزية ودعاة اللامركزية — وبين أولئك الذين يرغبون في أن ترمي العراق ماضيها العنيف وراء ظهرها وأولئك الذين صمموا على استنساخه. كما أن المطالب التي ذكرتها المعارضة الكردية والعربية السنية مراراً وتكراراً لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً. أولاً، تطلب المعارضة انتقال السلطة المالية إلى "حكومة إقليم كردستان" والمحافظات، ووضعها في قانون تقاسم الأرباح الذي سيقدم صيغة لنسبة الميزانية المخصصة لـ "حكومة إقليم كردستان" والمحافظات. ثانياً، تطلب المعارضة تطبيق نظام للضوابط والموزازين على السلطة التنفيذية — لاسيما من خلال تمكين البرلمان من القيام بهذه المهمة وضمان استقلال السلطة القضائية. ثالثاً، تطالب المعارضة بعملية مصالحة حقيقية وشاملة توفر العدالة لجميع المتضررين من نظام صدام، وليس العقاب الجماعي للسنة.
لقد وضعت الولايات المتحدة الأسس لهذه الأعراف الديمقراطية ويمكن أن تبقى ذات تأثير قوي لإعادة العراق إلى المسار السليم. وهناك بعض العلامات المشجعة في هذا الاتجاه. فقد بدأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التعاطي مباشرة وبحزم مع المالكي وهو يضع العراق ضمن الفئة الأولى من التحديات التي ينبغي معالجتها. وكان للولايات المتحدة دور فعال في التقريب بين المسؤولين العراقيين والأتراك لمناقشة مصالح الطاقة بين البلدين على المدى الطويل والتي تشمل إمكانية مرور خط أنابيب استراتيجي يمكن أن نرى من خلاله تدفق المزيد من النفط العراقي عبر الأراضي التركية والقليل منه عبر الممر الضيق لمضيق هرمز القريب من إيران. ونظراً لمواجهة المالكي الجماعات السنية المتشددة والتحديات الداخلية المتزايدة من داخل المجتمع الشيعي نفسه — كما يتضح من النتائج المتواضعة لانتخابات مجالس المحافظات — ربما ينفتح رئيس الوزراء العراقي على نحو غير عادي نحو اتخاذ خطوات تصالحية لإصلاح علاقاته مع الأكراد والعرب السنة والأتراك.
ومن المحتمل أن يستمر العنف في العراق في تدهوره طالما استمر التغالي في إعادة مركزية السلطة. وتحتاج المجتمعات العربية السنية والكردية الآن إلى سبب ملح يجعلها تبقى داخل الإطار المتفسخ الذي تعيشه العراق اليوم. وتقدم الانتخابات الوطنية عام 2014 فرصة ممكنة للبداية من جديد نحو عملية إعادة بناء الوطن، ولكن استبدال المالكي لا يمكن أن يكون شرطاً مسبقاً نحو استراتيجية جديدة لإنقاذ العراق. فمن الممكن جداً أن يفوز رئيس الوزراء: فهو يمتلك العديد من المزايا تجعله يتصدر الانتخابات والتي من بينها سيطرته على معظم الوزارات الرئيسية وجهاز الأمن والمخابرات فضلاً عن المحاكم الفيدرالية. والشيء الأساسي هو ضمان أن أي شخص يحكم العراق بعد انتخابات 2014 سيشعر بأقصى قدر من الضغط من المجتمع الدولي والفصائل العراقية للعودة إلى بناء وطن يتمتع بحرية واستقرار أكبر.
وإذا اختارت واشنطن مساندة دعاة اللامركزية العراقيين، فهي لن تكون وحدها. ولأسباب متنوعة خاصة بالفاعلين الذين يعملون في العراق هذه الأيام، فإن جميعهم تقريباً — المعارضة والأتراك وحتى الإيرانيين — سيرحبون بأية حكومة أقل إثارة للانقسام في بغداد. وبعبارة أخرى، إن الجهود المبذولة ستجد فرصة أكبر للنجاح.
كما أن تجربة بناء الرجل القوي الجديد في بغداد لم تسفر عن مزيد من الاستقرار للعراق. إن تخفيف الروابط التي توحد العراق أمر ينطوي على مخاطر جمة، بيد أن الإفراط في إحكامها ينطوي على مخاطر أكبر.
مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.
فورين پوليسي

 إسرائيل تستعد لاجتياح سيناء؟ تسريبات خطيرة تهزّ المنطقة!
إسرائيل تستعد لاجتياح سيناء؟ تسريبات خطيرة تهزّ المنطقة! صدمة إسرائيل بعدما توعدت طهران بمصير ضاحية بيروت
صدمة إسرائيل بعدما توعدت طهران بمصير ضاحية بيروت “رأس خامنئي” وهم نتنياهو الأخير
“رأس خامنئي” وهم نتنياهو الأخير ابن زايد يورّط الإمارات ويعرّضها لصواريخ إيران وغضبتها!
ابن زايد يورّط الإمارات ويعرّضها لصواريخ إيران وغضبتها! المعركة مع إسرائيل.. سلاح في قبضة إيران يخيف مصر
المعركة مع إسرائيل.. سلاح في قبضة إيران يخيف مصر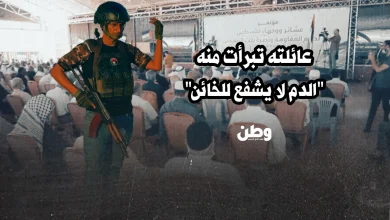 “دمه مهدور”.. عائلة أبو شباب تتبرأ من ابنها العميل وتدعو لتصفيته!
“دمه مهدور”.. عائلة أبو شباب تتبرأ من ابنها العميل وتدعو لتصفيته!